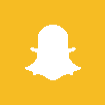عودة الثورة السورية إلى صباها الجميل
احتجت أن أمضي إلى العاصمة الأميركية كي أدرك من جديد حقيقة الثورة السورية بعدما علتها تشوهات لم تردها. دعتني الجمعية السورية الأميركية إلى مؤتمرها السنوي، والتي تعد أكبر تجمع للسوريين الأميركيين، وهم جالية معتبرة هناك. من بين النشاطات العدة التي نظموها عرض لفيلم «غاندي الصغير»، الذي يروي قصة شاب سوري حلم بالحرية واعتقد أنه يستطيع أن يطرق بابها بقنينة ماء ووردة بيضاء يهديها إلى جنود بشار الأسد وشبيحته لعلهم يقتنعون أنهم وهو شعب واحد، وأن حريته من حريتهم، ولكنهم لم يقتنعوا وقتلوه في بدايات الثورة. قتل غياث مطر، غاندي الصغير كما سمّاه محبوه، كان أحد شرارات الثورة ومن أسباب تحولها إلى العمل المسلح كرد فعل على بطش النظام الذي لم يترك لهم اختياراً آخر، على رغم أن رفاقه في الفيلم، وفي أروقة المؤتمر لا يزالون يتناقشون في ما إذا كان ممكناً إبقاء الثورة سلمية. من الواضح أنهم يتمنون ذلك، ولكن لم يعد ذلك اختياراً وقد عاشوا قصف مدينة داريا بالمدفعية الثقيلة، ثم بالطائرات والبراميل المتفجرة وكأنها جبهة حرب، وأخيراً محاصرتها وتجويعها، ولا تزال صامدة على رغم قلة من بقي فيها مع شحّ في السلاح والإمكانات، بينما استطاع النظام أن يدحر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) المدجج بالسلاح من تدمر الأسبوع الماضي، وهو الذي لم يؤمن يوماً لا بالتظاهرات السلمية ولا بحلم غياث في سورية ديموقراطية وتعددية بما في ذلك أنصار الرئيس، ولكنهم لم يستطيعوا اقتحام داريا. بينما كنت أشاهد الفيلم، تأكدت لي 3 حقائق ترسم مقبل الأيام للأزمة السورية، أولها عودة الثورة إلى صباها الجميل، حلم «الربيع العربي» وآماله، الثورة السلمية، شعارات الحرية، وذلك في التظاهرات التي عادت إلى المدن السورية المحررة من قبضة النظام و «داعش» معاً، وغابت فقط حيثما بقي النظام أو حيث حل «داعش» مكانه، فالاثنان سواسية في جينات الاستبداد وإن اختلفت تشوهاتهما النهائية. الحقيقة الثانية كانت في المفاصلة مع «جبهة النصرة»، التي تتماهى مع الثورة في ساحة الحرب عندما يعلو صوت الرصاص، ولكنها تتعارض معها في زمن السلم. خرجت تظاهرات في معرة النعمان وإدلب حيث لـ «النصرة» قوة وحساب، لم يطلب المتظاهرون من «النصرة» الرحيل وإنما أعلنوا عليهم الحرية، فروح الربيع العربي ترفض كل أشكال الاستبداد حتى من ذاك الذي يزعم أنه ينصر الثورة، الحرية في عرف المتظاهرين هي ألا يُفرض على أحد كيف يعيش، لتختر أيها «النصراوي» ما شئت من مدارج الحياة، تشدد كيفما شئت على نفسك، وأهل بيتك الضعفاء، ولكن ليس من حقك أن تفرض رؤيتك الضيقة على الناس والحياة. هذه المفاصلة مهمة، لأنها تشي باقتراب ساعة الختام، حين تسكت المدافع ويجلس المتفاوضون الحكماء لرسم سورية المستقبل، والتي لا بد أن تكون حرة تعددية، لا رؤية بشار ولا «داعش» ولا «النصرة» ولا كورد صالح مسلم. الحقيقة الثالثة، الانسحاب الروسي وجدية مفاوضات جنيف، وقبلهما وقف العمليات القتالية، صحيح أن كل ما سبق ليس مطلقاً، فالروس لا يزالون يساعدون النظام، والمفاوضات تتحرك ببطء، ويحاول النظام التملص من استحقاقها الحقيقي، وهو لزوم رحيله، كما أنه لا يزال ينتهك وقف العمليات القتالية، ولكن كل ذلك يشير ثانية إلى عودة الثورة إلى صباها وصبرها الجميل، فهي لم تُرِد يوماً أن تكون ثورة مسلحة، وتعلم ألاَّ قِبَلَ لها بالنظام وبطشه، ومصدر قوتها في إصرارها على الحرية، والجميع يعودون إلى أصلها وسببها الأول «ارحل ارحل يا بشار»، الهتاف نفسه الذي سمعه مبارك مصر وصالح اليمن وابن علي تونس وقذافي ليبيا. إنه الربيع العربي من جديد ولكن مثخناً مثقلاً بالجراح والإحباطات، ولكنه لا يزال ينبض. كان غياث مطر وهو يقدم قنينة ماء ووردة بيضاء لشبيح النظام، المشهد الأول للثورة السورية ضمن مشاهد عدة امتدت فوق كامل تراب وطن يتوق إلى الحرية، حديثه وأحلامه، مقتله والتمثيل بجثته، تشييع جثمانه وألم أهل داريا. ديبلوماسيون غربيون ليس بينهم سفير عربي واحد يحضرون عزاءه، ثم تتوالى المشاهد، شبان وشابات يتحدثون عن ضرورة العمل المسلح، آخرون يعارضونهم، تتحرر الضاحية من سيطرة النظام ويشعر أهلها بالحرية فيخرجون عن بكرة أبيهم يتظاهرون ويغنون للحرية، يختفي الخوف والتردد، فيقصفها النظام بالمدفعية، وسط الركام والدخان تختفي صورة غياث وسلميته. يتحدث رئيس النظام، فيصف المتظاهرين بأنهم مجرد عصابات مسلحة، تأتيه العصابات التي يريد، بأشكال عدة، الوطني منها، فلا يكتفي، يستمر بالقتل ويتحدث أكثر عن المؤامرة الخارجية، والإرهاب، والسعوديين والأتراك والقطريين. حتى ذلك الوقت لا يوجد في المسرح سوى شعب مقتول ونظام قاتل، ولكنه يريد إخفاء صورة غياث مطر وحمزة الخطيب وعشرات الآلاف الذين قتلهم. مع استمرار القتل، والتصريحات المستنكرة، واجتماعات باريس ولندن لمناقشة الأزمة السورية، نسينا نحن المتابعين من بعد، وكذلك السوري، كيف انطلقت الثورة وماذا أرادت؟ اختفت صورة الحرية والورود البيضاء، وبتنا نناقش خرائط سورية وألوانها بين «جيش حر» ومناطق النظام. ظهرت الطائفية بوجهها القبيح، ثم مشهد «داعش» الأقبح بلونه الأسود الذي كاد يخفي خلفه كل تفاصيل سورية الأخرى. توارت الثورة السورية في مقالات المحللين ولقاءات المسؤولين إلى مجرد «حروب بالوكالة» وتفصيل من تفاصيل التدافع السعودي الإيراني، حتى وصل هذا الفهم الخاطئ المشوش إلى ذهن الرئيس الأميركي باراك أوباما، فبات يصرح به في لقاءته الصحافية. في السنة الثالثة أو الرابعة من عمر الثورة، لم يعد أحد يتذكر غياث، أو حمزة الخطيب وغيرهما من رموزها، وإنما يترقب اجتماعاً بين كيري ولافروف وعادل الجبير وشاويش أوغلو، وزراء خارجية أهم الدول المعنية بالأزمة. محلل آخر تتضاءل الثورة في حبر قلمه إلى مجرد غضب وانتقام، أن بشار وصف الزعماء العرب بأنصاف الرجال في قمة عربية غير مهمة في حقبة عربية رحلت، وثالث يجعلها مجرد صراع دول وشركات غاز وبترول تريد مد أو منع أنبوب غاز يصل الخليج بأوروبا! وفجأة تتراجع كل هذه المشاهد المزدحمة، وتعود سورية، تقف في صدارة مسرح الأحداث تصرخ بمطالب الربيع العربي الأصلية البريئة، ذلك الحلم العربي الرائع الذي تمناه غياث بأقل التضحيات، وبسلام مجتمعي، ولكنّ تحالفاً غير متوافق بين الاستبداد والقوى الطائفية والمترددين، أحبط هذا التحوّل السلمي، ولكن لم يقتله. ذكرني غياث بشاب مثله: وائل غنيم، الذي كان من محركي ثورة 25 يناير المصرية، بعدما خرج من المعتقل عقب استقالة مبارك، وتوجه إلى استوديو برنامج «العاشرة» ليلتقي مقدمته الشهيرة منى الشاذلي. كانت مصر يومها غير مصر اليوم، عاطفة هائلة مشحونة بآمال وحب هائل للوطن سادت في جنبات المكان، استعرضت الشاذلي صور عشرات من الشباب الذين قتلوا في الثورة التي انتصرت للتو، انهار وائل باكياً مغمغماً أنه لم يكن يريد أن يموت أحد. اليوم وبعدما ساد القتل والخراب مدننا وأريافنا، لم يعد هناك أحد يبكي أن مات عشرات، بات الخوف أن يموت الوطن. نقلا عن الحياة
لا يوجد تعليقات