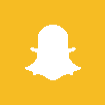كارهو تدوين التراث
اختار المسلمون أن يُدوّنوا علومهم الدينية بعد أن اختلفوا في ذلك، وجرى التأريخ العلمي لها على شكل، واتجهت العلوم في تكوّنها إلى ضرب، وكان في الإمكان أن تكون الأمور على غير ما هي عليه الآن؛ ليس لأنني أريد أن أرسم مستقبل ماضينا من خلال ما أراه في حاضري، من أمور جدّت وقضايا وُجدت، وإنما من خلال رأي قوم من الأسلاف معدودين من أهل الحكمة وسداد الرأي، كانوا كارهين لتدوين تلك العلوم، ومتجهين وجهة مختلفة عن تلك التي سار التأريخ عليها، وانتهت بنا إلى ما نرى من ضخامة التراث وصعوبة إحصائه، ينقل لنا رأي هؤلاء ابن حجر في "فتح الباري" قائلا:" فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة عن الرأي المحض، ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب، فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون، وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي، وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة، وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده".
ليس من شك أنّ التراث الإسلامي دُوّن كثير منه وحفظ، واقتطعت أجيال من المسلمين أعمارها في جمعه واقتصاص آثاره، ولم يعد من السهل لحيٍّ أن يُعارض ما ثبت وسُطّر، ولم يكن لأحد أن يرفض ذلك ويحتج عليه، وقد وقف بين يديه شاهدا على ما كان في تلك الأزمان والحقب، فلم يعد في الاعتراض على القائم كبير نفع وفائدة؛ لكن بقي لنا تجاهه أن نتساءل حوله، ونُديم النظر فيه.
جرى قلم التدوين في السنة النبوية وتفسير القرآن وجمع شتات الآراء الفقهية، جرى القلم بكل ذلك؛ لكن القلم نفسه دوّن لنا آراء أولئك الذين كانوا على خلافٍ مع حاملي القلم، ها هو القلم قد حفظ أسماء الأئمة الذين لم يدعوا إلى التدوين، بل وقفوا ضده، وسعوا إلى نبذه والتنادي لتركه.
إنّ هؤلاء الذين أنكروا التدوين في السنة، وهما أبو حفص الفاروق وأبو موسى الأشعري، وأولئك الذين لم يرضوا تدوين التفسير، وهم الشعبي وجماعة، وأولئك الذين كرهوا تدوين الآراء الفقهية المحضة، وهم الإمام أحمد وجماعة معه، إن هؤلاء جميعا لم يكن المنع منهم أو الكراهة عندهم مرجعها إلى المنع والكراهة المطلقين، لم تملّ نفوسهم إلى التوقف في التدوين رغبةً عن الحفظ نفسه، فمثلهم لا يغفل عمّا في الكتابة من صون عن الضياع، وحفظ من الزيادة والنقصان؛ لكن لهم داعيهم إلى ما رغبوا فيه، فما ذلكم الداعي، وما تلك القضية التي جعلتهم يأنفون من الكتابة والتدوين؟
لم يكن هؤلاء الذين رغبوا عن التدوين يجهلون ما فيه، ويستصغرون ما يأتي به، ويغفلون عما يُنتظر منه؛ لكنهم كانوا يُفكرون بطريق غير الذي نفكر به، وينتهجون دربا آثرنا السير في سواه، إنهم كانوا ينظرون إليه نظرَ المرتاب، نظرَ من يخافُ جريرتَه، نظرَ مَنْ يُريده ولا يريده، نظر من يُغلّب مفاسده على مصالحه، إنهم تركوه للسبب الذي به طلبناه، ويرفضونه ونفرح بوجوده، ويصدون عنه ونتمسك به.
إنّ الداعي لهم في الترك هو الداعي لنا للفرح به، إنه لأمر غريب، إنه لمريب أن نفرح من حيث كان أَساهُم، ونسعد من حيث كان خوفهم، ونهنأ من حيث كان قلقهم!
إنّ الناظر في الكلام الذي فاه به الفاروق ـ رضي الله عنه ـ بعد أن استخار واستشار يجد الخوف يتملكه على القرآن الكريم أن يَتركه المسلمون، ويستعيضون عنه بالسنة والآثار، لم يكن أمام الفاروق أيُّ تحدٍّ يحول بينه وبين تدوين السنة والأثر، ولولا ما برق في مخيلته من خوف على كتاب الله ـ عز وجل ـ لكان أول الناهضين إلى تدوين السنة وجمعها، وكل ذلك جلي واضح، فلم يكن الفاروق ـ رضي الله عنه ـ يتجاهل قيمة السنة وأهميتها؛ إذ لولا ما كان يستشعره من قيمتها ما استشار ولا استخار.
يكشف الفاروق عن العلة التي مالت به عن ترجيح التدوين قائلا:" إني كنت أريد أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبّوا عليها، وتركوا كتاب الله، وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا".
لم يكن أمام الفاروق مانع من تدوين السنة سوى الخوف على القرآن أن يدع الناس الاهتمام به، والحرص عليه، والغريب في الأمر أن الرجل ـ رضي الله عنه ـ اتخذ قرارا مصيريا ـ كما يقال ـ بظنٍ ظنّه، والغريب أيضا أن يتنازل عن السنة لهذا الظن، والغريب أيضا أن يترك تدوينها مع ما يشاهده من دورها في تفسير القرآن وإيضاحه، فتدوينها ـ بهذا الوجه ـ جزء من تدوين القرآن الكريم، كل هذا ويرْتأي الفاروق الترك؟
ربما يبدو للبعض أن الفاروق ـ وكما يوحي ظاهر عبارته ـ خاف اختلاط السنة بالقرآن" وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا"؛ لكن قوله:" كتبوا كتبا فأكبّوا عليها، وتركوا كتاب الله" يبعد هذا الفهم ويقصيه، فالقرآن مدون ومكتوب، وليس الشوب إلا في اهتمام الفاروق وعنايته، فهو لا يُريد أن يكون له اهتمام بغير القرآن، إنه لا يريد أن يشوبَ اهتمامَه وعنايتَه بشيء غير القرآن، إنه يسعى لمنع أن يشارك غير القرآن القرآنَ في عناية الناس واهتمامهم، فالمحظور عنده أن يُخالط غير القرآن القرآنَ في تنادي الناس وتدافعهم.
وشبيهٌ بهذا ما روي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ حين أحضر له بعض الناس صحيفة فيها أحاديث حسان ـ كما يقولون ـ فمحا ما في الصحيفة، وقال لهم:"القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بما سواه".
إذا كان ترك الناس للقرآن هو الحافز للفاروق وابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ لما فعلاه وقاما به، فما الذي سيفقده الناس حين تكون قواهم موجهّة للسنة والأثر، وعقولهم معينة بهما؟ ما المغزى من وراء قول الفاروق وابن مسعود؟ لماذا خافا على القرآن أن تنتزع السنةُ الناس منه؟
ما الذي سنفقده حين نهتم بالسنة أكثر من اهتمامنا بالقرآن الكريم؟ أليست السنة من القرآن؟ أليس القرآن في أغلبه حديثا عن الله ـ عز وجل ـ وقصصا عن الأمم قبلنا، وليست أحكام الحلال فيه والحرام إلا نزرا يسيرا، وهي أمور لو أراد العادّ أن يعدها لأحصاها، فما الذي سيذهب إذن حينما تأخذ السنة جزءا من رعايتنا؟
إنّ موقف الفاروق من تدوين السنة يفتح باب السؤال عن رأيه في تدوين التفسير وتدوين الآراء الفقهية المبنية على الرأي المحض، فما كان الفاروق يقول لو جدّ في زمانه التفكير في تدوين التفسير وهذه الآراء؟
حينما أقرأ مثل هذه النصوص أشعر أن أصحابها كانوا يرومون ترك النص مفتوحا غير مقيد بآرائهم ومواقفهم، كانوا يقفون من آرائهم خلاف موقفنا نحن منها الآن، إنهم يرونها قيودا لحرية النص الذي يجب أن يكون بعيدا عن كل قيد بشري، إنهم ينظرون إلى آرائهم في القرآن على أنها جزء من دلالته، وليست استقصاء لما فيه، إنهم يُعلّموننا أنّ العلم ليس فيه حقائق مطلقة، لا تقبل الزيادة والنقص والترميم، ولم يكن لهؤلاء القدوات أن يدعوا إلى ما ننسبه اليوم إليهم، كيف ومقالة أبي بكر المشهورة ما برحت في أذهاننا "أي سماء تظلني وأي أرض تقلني...".
إن أبا بكر من خوفه ـ وهو من أعلم الناس بالقرآن ـ لم يجرُؤ أن يفسر القرآن برأيه، وكل ذلك مخافة أن يأخذه الناس عنه، ثم يقولوا ـ كما يقولون اليوم ـ: هذا تفسير الصديق، وكفاك به، فالصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ كانوا يستشعرون هذا الوباء الخطير، وهو أن الناس ـ طال الزمان أم قصر ـ سيأخذون أقوالهم على أنه الحق الذي لا مرية فيه، ولهذا حذروا ونبهوا؛ لكن من الغريب أن تمضي سفينة الحياة على خلاف ما أرادوه.
نقلا عن الرياض